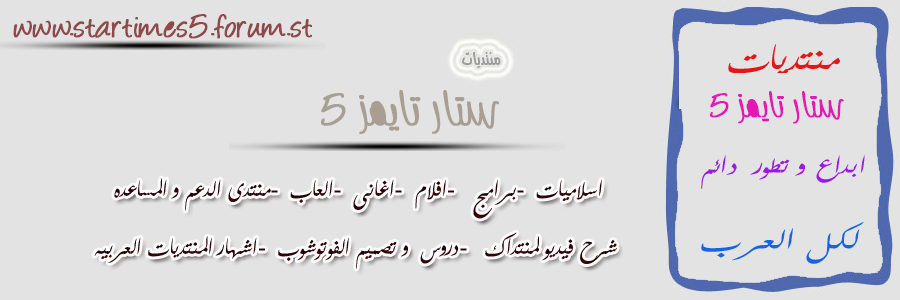منهج الإسلام مع البغاة والخارجين
قد يحدث أن جماعة لا يؤمنون بالنصوص الداعية إلى الحفاظ على الوحدة، أو يؤولونها تأويلاً يخدم أغراضهم الشخصية في تولي زمام السلطة، يدفعهم إلى ذلك في الغالب دافع يمت بصلة إلى عصبية أو حزبية أو أي شيء آخر يتخذ الدين ستارًا يبعد عنه التهمة، ويخفي وراءه الحقيقة.
وهؤلاء موجودون من قديم الزمان، وعرفهم التاريخ الإسلامي في سنواته الأولى، ونريد هنا أن نسجل صورة من الإجراءات التي قررها العلماء الأولون لمواجهة هذا الانحراف، كما ذكرها الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية» وهي تتناول الانحراف في الرأي والانحراف في السلوك.
قال ما ملخصه: إذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم يخرجوا به من المظاهرة بطاعة الإمام، ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفراد متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد – تركوا ولم يحاربوا، وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض قوم من الخوارج لعلي بن أبي طالب رضوان اللَّـه عليه لمخالفة رأيه، وقال أحدهم، وهو يخطب على منبره: لا حكم إلا للَّـه، فقال علي رضي اللَّـه عنه: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد اللَّـه أن تذكروا فيها اسم اللَّـه، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا.
فإن تظاهروا باعتقادهم، وهم على اختلاط بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبًا وزجرًا، ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد، لحديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس».
فإن اعتزلت هذه الفئة أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة، فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق. فقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليًّا عليه السلام بالنهروان، فولى عليهم عاملاً أقاموا على طاعته زمانًا وهو لهم موادع إلى أن قتلوه، فأنفذ إليهم أن سلموا إليّ قاتله، فأبوا، وقالوا: كلنا قتله، قال: فاستسلموا إليّ أقتل منكم، وسار إليهم فقتل أكثرهم.
وإن امتنعت هذه الطائفة من طاعة الإمام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا باجتباء الأموال وتنفيذ الأحكام، فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إمامًا ولا قدّموا عليهم زعيمًا كان ما اجتبوه من الأموال غصبًا لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من الأحكام مردودًا لا يثبت به حق.
وإن فعلوا ذلك وقد نصّبوا لأنفسهم إمامًا اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام، لم يتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة، وحوربوا في الحالين على سواء، لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة، قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9].
فإذا قلد الإمام أميرًا على قتال الممتنعين من البغاة، قدم قبل القتال إنذارهم وإعذارهم، ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي كفاحًا ولا يهجم عليهم غرة وبياتًا.
ثم تحدث الماوردي عن موقف المسئولين من المخربين والمفسدين والعابثين بالأمن، وهم المنحرفون في السلوك لا في العقيدة، فقال: وإذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة – المرور – فهم المحاربون الذي قال اللَّـه فيهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33].
ثم ذكر خلاف الفقهاء في حكم الآية وتطبيقها على المحاربين، فقال: إن هنا ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن الإمام ومن استنابه لقتالهم من الولاة مخير أن يقتل ولا يصلب، وبين أن يقتل ويصلب. وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وبين أن ينفيهم من الأرض.
والثاني: أن من كان منهم ذا رأي وتدبير قتله ولم يعف عنه، ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف، ومن لم يكن منهم ذا رأي ولا بطش عزره وحبسه فجعلها مرتبة باختلاف صفاتهم لا باختلاف أفعالهم، وهو قول مالك.
والثالث: أنها مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن كثر وهيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عزر ولم يقتل ولم يقطع، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار بين قتلهم ثم صلبهم، وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، ومن كان معهم مهيِّبًا مكثرًا فحكمه كحكمهم.
والمراد بالنفي في قوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض} قيل: هو الإبعاد من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، وقيل إخراجهم من مدينة إلى أخرى، وقيل هو الحبس، وقيل غير ذلك.
ثم ذكر الماوردي أن هؤلاء المحاربين إذا كانوا على امتناعهم مقيمين، أي مصرِّين على سلوكهم، قوتلوا كقتال أهل البغي في عامة أحوالهم، وذلك لأن للقتال أسلوبًا يختلف من المرتدين إلى البغاة إلى الخارجين على الأمن، لا داعي لتفصيله.
وبعد هذا العرض يهمّنا أن نعرف أن البغاة، وهم أهل فكر معين ينشقون به عن فكرة الجماعة، إن تستروا بفكرهم ولم يدعوا إليه ولم ينحرفوا في سلوكهم فليس للسلطة يد عليهم، فإن دعوا إلى فكرهم وجب على المسئولين أن يصححوا أفكارهم بالحوار، أو بأية طريقة أخرى تقوم على التوعية الصحيحة والنقاش الموضوعي الهادف، وفي الوقت نفسه يجوز للسلطة أن تعاقب من يروجون لفكرهم بما تراه من عقوبة لا تصل إلى القتل أو إلى حد من حدود الجرائم المعروفة.
ولو انفصلت هذه الجماعة وتميزت بدار أو محلة وكانت ملتزمة بالقوانين الجارية دون عدوان ولا فساد، فلا شأن للسلطة بهم، إلا ما يكون من توعية لتصحيح الفكر، فإن تمردت على القوانين وكوّنت لنفسها دولة داخل الدولة كان للسلطة أن تحاربهم لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة.
أما العابثون بالأمن، سلوكًا لا يحملهم عليه فكر مخالف لفكر الجماعة، فالأقوال مختلفة في الأسلوب الذي يتخذ معهم، وللسلطة أن تختار منها ما يحقق المصلحة.
وبهذه المناسبة نقول: إن عقوبة التعزير للمخالفات التي ليست لها عقوبة محددة عقوبة مشروعة، وهي متروكة لتقدير القاضي أو الحاكم الذي يضع القانون، والأصل فيها حديث أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، وصححه الحاكم، وثبت أن عمر رضي اللَّـه عنه كان يعزر ويؤدب بحلق الرأس والنفي والضرب بالدرة، واتخذ دارًا للسجن، ومما يشهد لتركه لتقدير الحاكم أو القاضي حديث أحمد والنسائي وأبي داود: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود»، أي لا تؤاخذوهم على زلتهم، وبخاصة إذا لم تتكرر، وإن عاقبتموهم فليكن العقاب خفيًّا.
وقال بعض الفقهاء: لا يزيد التعزير على عشرة أسواط، لحديث البخاري ومسلم: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّـه» وهو ما رآه أحمد وبعض الشافعية، وأجاز مالك والشافعي الزيادة على العشرة، لكن لا يبلغ أدنى الحدود، ورأى الأحناف التعزير بالقتل، ويسمى القتل سياسة، كما رآه بعض الحنابلة، وعلى الأخص ابن تيمية وابن القيم، وكذلك قليل من المالكية، وذلك إذا اقتضته المصلحة العامة، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كالجاسوس ومن يدعو إلى البدعة ومن يعتاد الجرائم الخطيرة، وقد جاء في صحيح مسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» وفسره النووي بأن قتله جائز إذا لم ينته عن سلوكه إلا بالقتل. [حاشية ابن عابدين: ج4 ص247، الاقناع: ج4 ص271، الطرق الحكمية لابن القيم ص106، التشريع الجنائي لعبد القادر عودة: ج1 ص688].