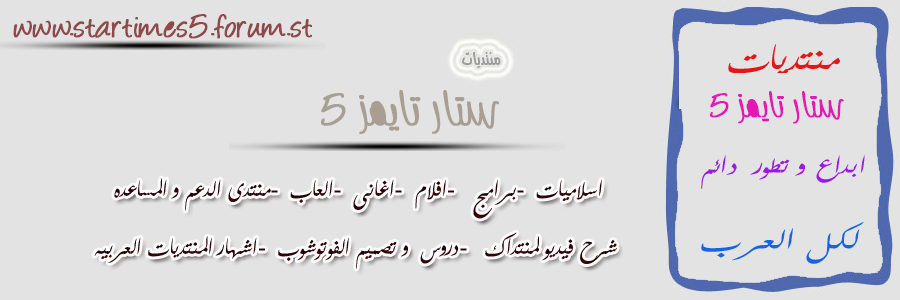انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"؟!
استوقفني لفظ هذا الحديث كثيراً, وكنت دائماً أجد فيه معاني في غاية الأهمية, تتعلق بموقفنا من المختلِف: فكرا وثقافة وحضارة!
وكان الذي استوقفني فيه: هذا الأسلوب النبوي في الموقف من هذا المثل الجاهلي وفي طريقة تصحيحه لمعناه: من المعنى الجاهلي الساقط, إلى المعنى الإسلامي الراقي. وقد كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يُـحرِّمَ إطلاقَ هذا المثل, وأن يمنع من التلفّظ به, وأن يستبدله بعبارة: «انصر أخاك مظلوماً, وأما إذا كان ظالمًا: فاردعه عن أن يكون كذلك, بأن تمنعه من ظلم غيره, وأن تنتصر للمظلوم, ولو كان ضد أخيك», فلماذا تجاوز النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا التصريح, واختار ذلك الأسلوب اللطيف في التصحيح بالتلميح؟
بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مضطراً لذكر هذا المثل أصلاً لكي يحاربه ويلغيه من الوجود؛ إذ كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يتجاهل هذا المثل, وأن يهجره بالكلية, فلا يذكره: لا ناقدًا, ولا مصحِّحًا, وكان هذا وحده كفيلاً لكي يؤهّل هذا المثل للانقراض, مع غيره من الـمُثُل الجاهلية الباطلة المنقرضة ببزوغ فجر تعاليم الإسلام التي بينت فسادها, وسيجد الصحابة (والمسلمون من بعدهم) في قواطع نصوص الكتاب والسنة ما يدل على ذلك المعنى التصحيحي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم له, دون أدنى حاجة إلى ذلك التأويل للفظ الباطل ليوافق المعنى الحق!! فلماذا هذا الحرص على ذلك اللفظ الباطل القادم من عصر الباطل إلى عصر الحق؛ ليكون في عصره بالمعنى الحق؟!! هذا ما يجب أن يستوقفنا:
ولي مع هذا الموقف النبوي الحكيم تأملاتٌ عدّة:
الأولى: في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للعبارة الجاهلية: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا», ما يُرشِدُ إلى أن التصحيح ينبغي ألاّ تعوقه كثيرًا الألفاظُ والظواهر؛ بل ينبغي أن يقف كثيرًا مع المعاني والحقائق. وهذا يبيّنُ أن منهج (تسمية الخمر بغير اسمها) إنما كان باطلاً لأنه كان بقصد الترويج للباطل, بتلبيس الباطل باسم الحق. وأما إذا كان للترويج للحق: ولو بإطلاق لفظٍ باطل على معنى صحيح, فهو منهجٌ صحيح؛ لأنه بهذا الحديث منهجٌ نبوي؛ ولأنه نصر الحق وأيّده!
الثانية: أن هذا التصحيحَ النبويَّ يُبيّنُ أن من سياسة الإصلاح الحكيمة عدمَ استفزاز المجتمعات بإشعارها أن إصلاحَها رهينُ انقطاعها التام عن ماضيها وثقافتها, بل إن حكمة هذه السياسة -لتطمئن تلك المجتمعات- إلى أنه يوجد في ماضيها ما هو خير, ففي ماضيها: (1) ما هو صحيح لا يحتاج إلى تصحيح أصلاً, مثل مكارم الأخلاق التي إنما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمِّمها في مجتمع العرب الجاهلي. (2) وفي ماضيها أيضًا ما يختلط فيه الخطأ بالصواب, ولذلك فمن الممكنِ تصحيحُه مع بقاء أصله, ولو بنوعٍ من التأويل الذي ينبو عنه الظاهر, ولو بتجاوز ظواهر المعاني إلى تغيير حقائقها, ولو بإقرارِ شعارٍ من شعارات الباطل لكن مع تصحيح معنى ذلك الشعار.
فعلى المصلِح ألاّ يُـحْدِثَ بين المجتمع وماضيه هُوّةً؛ إلاّ عند الضرورة؛ لأن هذه الهوة سببٌ لنفور المجتمع عن الإصلاح؛ فينبغي أن يكون اللجوء إليها لا يتم إلاّ عند اضطرار الإصلاح إليها. وعلى المصلح (حسب المستطاع) تقليلُ حجم هذه الهوة إذا اضُطرَّ إليها (فالضرورة تُقدَّر بقدرها), على أن يكون تقليله لحجمها بالقدر الذي لا يؤثر على إصلاحه بالإساءة والتقصير؛ لأن هذه الهوة نفسها تؤثر على الإصلاح, بنفور الناس عنه. وهذا ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الموقف: فقد ربح تصحيحَ الخلل, وربح معه عدمَ إحداثِ هُوّةٍ لا داعي لها تَـفْصِلُ إصلاحَه عن ماضي المجتمع العربي وثقافته. في حين أنه صلى الله عليه وسلم لما كانت عقيدة التوحيد لا يمكن أن تستقر ولا أن تُنجي المجتمع من الشرك إلاّ ببيان المفاصلة التامة بينها وبين الشرك = أوضح ذلك بكل وضوح, ولم يقبل في بيانه أدنى تنازل أو مساومة!
وفي موطن آخر يؤكد النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا المعنى, فيقول: «إنما بُعثتُ لأتمّم مكارم الأخلاق», وفي هذا اللفظ حصرٌ واضحٌ وعجيب لمضمون الرسالة كلها في التتميم والتكميل لما كان عليه العرب في الجاهلية من الأخلاق. وهذا منهجٌ نبويٌّ من مناهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة: وهو (كما سبق) أن نُشعرَ المجتمعَ الذي ندعوه بأن جوانب الخير فيه كثيرة, ونقنعه أننا لذلك سوف ننطلق منها في الإصلاح, فلا يصحُّ أن نُشعره بأن بينه وبين الإصلاح مسافةً كبيرة جدًّا, ولا يصح أن نقرّر له بأنه لن يصل للصَّلاح إلاّ إذا انقطع تماماً عن مبادئه وقيمه وماضيه وعاداته! بل لا بدّ أن يقتنع بأننا من الصالح الذي هو فيه.. سوف ننتقل منه لإصلاحه, وأن في حقِّه.. ما يكفي لإزهاق باطله, وأن في صوابه.. ما يدل على تصحيح خطئه، ما أمكن ذلك، وحقق الإصلاح الذي نسعى إليه, كما في هذا الحديث الشريف الواضح.
الثالثة: وفي هذا الموقف النبوي ما يدل على نفسية الواثق التي تعامل بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مع المعنى الجاهلي لهذا المثل: فلم يهجر اللفظ, ولا طالب بعزله أو الانعزال عنه, ولا طالب بتصحيحه صراحة! ولكنه تواصل معه, ومزجه ببقية تعاليمه, وتأوّل معناه بما تتفق العقول الصحيحة على عدالته, وتأتلف النفوس السوية على حبه والميل إليه.
الرابعة: وأن القوة التي جعلت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينطلق في معالجته لهذه الفكرة هذا المنطلَقَ الواثق, ليست قوةً نابعة من التفوق العسكري, ولا من التقدم الصناعي, ولا من السيطرة الاقتصادية, ولا من السلطان الإعلامي, ولا غير ذلك مما لا علاقة له بحقيقة الثقافة (وإن كانت هذه القُوى كلُّها واجباتٍ مطلوبةً من الأمة) = لكنها قوةٌ وثقةٌ نابعةٌ من ذات الثقافة بالدرجة الأولى؛ لأن القضية هنا (في معالجة هذا المثل) قضيةٌ ثقافية. ومصدر هذه القوة في الثقافة الإسلامية هو أنها ثقافة الحق المطلق؛ لأنها تعتمد الحقَّ المطلق: الوحي الإلهي! وهذه خصيصة تنفرد بها الثقافة الإسلامية الحقة, وليست لأي ثقافة سواها.
الخامسة: لما تواصل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع ذلك اللفظ الجاهلي ذي المعنى الجاهلي, مع تصحيحه ذلك التصحيح الذي تجاوز معضلة ظاهر اللفظ الواضح في البطلان إلى تأويله بمعنى ساطع الـحَـقَّانيـّـة والبرهان، صحّحَ الخلل, وجعل العقول هي التي تتحرك لمحاكمة تراثها الفكري, دون إملاءات مستفزة. ولا يعني ذلك أن التصحيح الصريحَ خطأٌ مطلقاً, ولكني فقط أردت التنبيه إلى أن التصحيح بالتلميح ليس خطأ مطلقاً. بل إن التصحيح بالتلميح قد يكون هو الحكمة, فيكون هو المطلوب شرعًا في بعض المواقف. وليس هو دائماً من دلائل ضعف المصلحين, وليس من الخصائص التي تنفرد بها مرحلة الاستضعاف وحدها.
السادسة: في هذا الموقف ما يدل على أن الثقافة القوية لا تخشى من الثقافة الضعيفة. فليس من الصحيح أن يخشى المسلمون من أي وافد على ثقافتهم, ولو كان هذا الوافد خطأ عند الذي صدّره إليهم: ما دام من الممكن تصحيحه, وبشرط أن يتم تصحيحه فعلاً. وأما إذا ما تم تصديره فعلاً, ودخل إلينا وأصبح جزءًا من واقعنا, وصار من غير الممكن إلغاؤه. مثل تداول بعض المصطلحات الوافدة: بدءاً من التنوير, والحرية, مرورًا بالديمقراطية واللبرالية, إلى غيرها من المصطلحات الوافدة.
فالمصطلح إذا أصبح شائعًا, فلا مانع من استعماله, بشرط أن نكون قادرين على تصحيح معناه, عن طريق التنبيه الدائم على معناه الصحيح (التصحيحي), لنقاوم به المعنى الباطل فيه.
وأما محاولتك محاربةَ هذا الوافد (من مثل بعض تلك المصطلحات), بعد أن أصبح جزءًا من الواقع, وأنت عاجزٌ عن صدّ الوافد الجديد، فضلاً عن الوافد القديم الذي استقر وتوطّنَ في الفكر والثقافة، فلا تنفعنا محاربتُك له حينها إلاّ هزيمةً جديدة, لا تحقق الإصلاح! وإذا كنا مخيرين بين هزيمتين (هزيمةِ قبول الوافد الخاطئ مع العجز عن تصحيحه التصحيح الكامل, وهزيمةِ العجز عن رفضه بالكلية) فليس لنا إلاّ أن نختار أهون الهزيمتين ضررًا, وأقلها خسائر, وأولاها بأن تخلخل صفّ المخالفين, وأن نسعى بألاّ تؤكد الهزيمةُ على شدة ضعفنا وبُعدنا الكامل عن الانتصار؛ لأن الهزيمة النفسية الناتجة عن ذلك أشد من أيِّ هزيمةٍ في ساحة الواقع المادي (عسكرياً كان أو إعلامياً)؛ فالهزيمة الكاملة هي الهزيمة النفسية, التي لا يبقى معها لروح النضال والمقاومة أي وجود, بل الهزيمة النفسية هي التي تجعل المهزوم يصطف مع العدو ضد أمته ووطنه؛ لأنها لا تقع لشخص أو أمة؛ إلاّ ويقع عقبها مباشرة الإعجاب بالعدو الغاصب, إلى درجة اتخاذ العدو الغاصب إمامًا يُقتدى به.
السابعة: كلما كانت الكلمات التي تشيع في أحد المجتمعات أكثر رسوخاً فيه, وتتعلق نفوسهم به كشعار لثقافتهم, حتى صار مكوِّنًا لشخصيّتهم، كانت عدم مصادمته الصريحة أولى بنجاح عمل المصلحين. خاصة إذا كان في تلك الكلمات جزءٌ من الحق, مثل «انصر أخاك مظلوماً», ومثل: مدح حب القريب والثناء على قوة الصلة به, وهي المعنى الصحيح الذي انطلقت منها العبارة الخاطئة «انصر أخاك ظالماً». ومثل شعار الحرية والديمقراطية: الذي يقابل ويُضادّ الاستعباد والاستبداد والتسلّط, فهذه المعاني الصحيحة هي أرضيته التي تسوّق لمعانيه الصحيحة والخاطئة.
هذه بعض الوقفات التي سمح بها الوقت, وما زال لكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- سرٌّ تقف دون عظمته حكمةُ الحكماء!!